سد النهضة الإثيوبي: بين طموح التنمية وشبح الأزمة المائية
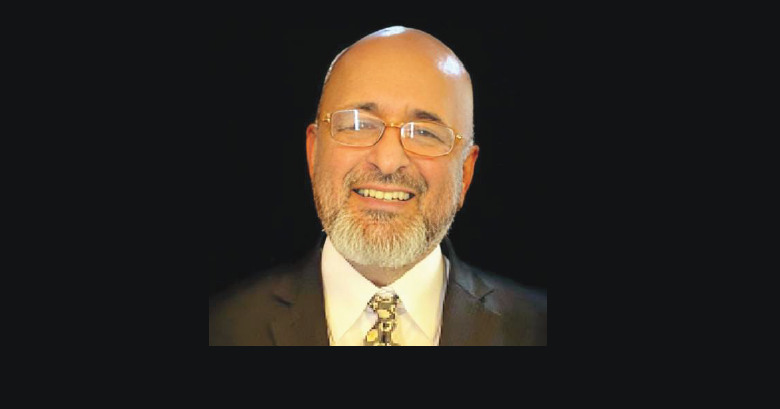
بقلم/ د. عدنان البدر
باحث ومستشار استراتيجي في سياسة الموارد بشرية وبيئة العمل ورئيس ومؤسس الجمعية الكندية الكويتية للصداقة والأعمال
ckbafa@gmail.com
كيف مولت الدولة الفقيرة أكبر سد في أفريقيا؟
تمويل جزئي عبر سندات حكومية وتبرعات من المواطنين والمغتربين، مما جعله رمزًا للفخر الوطني والإرادة الجماعية.
سد النهضة نقلة نوعية لإثيوبيا، من هامش التنمية إلى مركز التأثير في القارة.
افتتاح سد النهضة يضع الجميع أمام مسؤولية تاريخية. إنه اختبار حقيقي لإرادة التعاون الإقليمي.
هل يكون سد النهضة نقطة انطلاق لعهد جديد من التعاون الإقليمي والازدهار المشترك؟
إما أن يكون السد سبيلا للتنمية المستدامة، أو مصدراً للتوتر والصراع.
آثار سد النهضة الاقتصادية المتوقعة تشمل تلبية الطلب المحلي على الطاقة لعدد سكان يبلغ 135 مليون نسمة، يعيش نصفهم بدون كهرباء.
السد يمكّن إثيوبيا من تصدير الطاقة لتحقيق التفوق الإقليمي وزيادة إيراداتها من النقد الأجنبي.
بطاقة تصميمية تبلغ 6450 ميغاواط، أصبح سد النهضة أكبر محطة لتوليد الكهرباء الكهرومائية في أفريقيا.
يشكل السد نقطة جذب للمستثمرين في قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية.
سدود اليوم تحتاج إلى استثمارات ضخمة في الصيانة والتجديد، ورقابة علمية دقيقة لتقليل الخطر وضمان استمرار الفوائد.
المتوسط المتوقع لعمر السد النموذجي يتراوح بين 50 إلى 100 عام.
افتتاح سد النهضة: فاصل النيل بين الحلم الإثيوبي والمخاوف المصرية–السودانية
بقلم/ عدنان البدر
سد النهضة: حلم إثيوبي وبداية عصر جديد في حوض النيل
في لحظة فارقة، افتتحت إثيوبيا رسميًا “سد النهضة الإثيوبي الكبير” يوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، بعد 14 عامًا من أعمال البناء، لتكتب صفحة جديدة من التاريخ في قلب القارة السمراء. وعلى ضفاف النيل الأزرق، يلامس المشروع أحلام التنمية الوطنية، بينما يلقي بظلال ثقيلة من القلق والجدل الجيوسياسي على مصر والسودان، ويضع حوض النيل أمام معادلة دقيقة، تُعيد تشكيل توازن القوى الإقليمية. بافتتاح سد النهضة الإثيوبي الكبير، دخل حوض نهر النيل مرحلة جديدة بالكامل، تحمل في طياتها وعودًا بالتنمية لملايين الإثيوبيين، بينما تثير في الوقت نفسه عاصفة من القلق والتحديات لمصر والسودان، الدولتين اللتين تقعان مصبًّا للنهر . شهد حوض النيل لحظة فارقة مع الافتتاح الرسمي لسد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي يمثل نقطة تحول في تاريخ المنطقة. يقف هذا المشروع العملاق على ضفاف النيل الأزرق، حاملاً معه أحلام إثيوبيا في التنمية والازدهار، بينما يثير في الوقت نفسه قلقاً بالغاً وجدلاً سياسياً في مصر والسودان. يُعيد السد تشكيل التوازنات الإقليمية ويضع الجميع أمام معادلة جيوسياسية دقيقة.
سد النهضة بالأرقام والمواصفات:
يعد سد النهضة الإثيوبي الكبير أكثر من مجرد منشأة هندسية؛ فهو يعبر عن طموح إثيوبي كبير. تتلخص أبرز مواصفاته فيما يلي:
– الأبعاد الهندسية: استمر بناء السد لمدة 14 عاماً، واجه خلالها العمال والمهندسون تحديات جسيمة، سواء على المستوى الجغرافي أو السياسي. أصبح المشروع رمزاً للعزيمة الوطنية، ووصفه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بأنه حجر الأساس لازدهار البلاد. رافقت عملية البناء حملة تمويل وتبرعات شعبية غير مسبوقة، مما جعل السد قضية وطنية تحتل مكانة مركزية في الوعي الجمعي الإثيوبي. فقد تم تمويل هذا الحلم جزئيًا من خلال تعبئة شعبية غير مسبوقة، عبر سندات حكومية وتبرعات من المواطنين والمغتربين، مما جعله رمزًا للفخر الوطني والإرادة الجماعية. يبلغ ارتفاع السد 145 متراً، وطوله 1.8 كيلومتر. وتضم محطة التوليد 13 وحدة توليد بقدرة إجمالية تصل إلى 5150 ميغاواط.
– التكلفة والتمويل وهندسة الأحلام، إنجاز شعبي وإقليمي: بلغت تكلفة المشروع حوالي 5 مليارات دولار، تم تمويلها جزئياً عبر إصدار سندات حكومية وتبرعات شعبية تجاوزت 169 مليون دولار. كما ساهمت شركات صينية في تمويل خطوط النقل وتقديم التقنيات الكهرومائية، بينما تولت شركة إيطالية عملية البناء والإشراف الهندسي.
– القدرة الكهربائية: لم يكن هذا السد مجرد مشروع هندسي ضخم، بل كان تجسيدًا لحلم قومي لإثيوبيا، دولة تسعى للخروج من دائرة الفقر وندرة الطاقة. حيث يُعتبر أكبر محطة لتوليد الكهرباء الكهرومائية في أفريقيا، بطاقة تصميمية تبلغ 6450 ميغاواط. تتميز الطاقة الناتجة عن السدود بأنها قابلة للتحكم وسريعة الاستجابة للطلب على الكهرباء، وتساعد أيضاً على تنويع مصادر الطاقة الوطنية وتقليل الاعتماد على النفط والغاز. بجانب ذلك، توفر السدود فوائد إضافية مثل تنظيم الفيضانات وتأمين مياه الري والشرب وتقليل الجفاف.
– السعة التخزينية: تصل إلى نحو 74 مليار متر مكعب، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف إجمالي سعة السدود في إثيوبيا. تمتد البحيرة الصناعية على مساحة 1874 كيلومتراً مربعاً، مما يفتح آفاقاً للاستثمار في السياحة والثروة السمكية.
لم يكن هذا السد مجرد مشروع هندسي ضخم، بل كان تجسيدًا لحلم قومي لإثيوبيا، دولة تسعى للخروج من دائرة الفقر وندرة الطاقة. فقد أصبح سد النهضة أكبر محطة لتوليد الكهرباء الكهرومائية في أفريقيا. بسعته التخزينية الهائلة، لم يعد المشروع مجرد منشأة للطاقة، بل أصبح أداة تحكّم رئيسية في تدفق مياه النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل.
الفوائد داخلياً وإقليمياً
-مكاسب تنموية: يوفر السد طاقة مستدامة للمصانع والمدارس والمستشفيات، ويعزز مشاريع الري والزراعة، ويفتح آفاقاً جديدة في مجال السياحة والثروة السمكية.
– جذب الاستثمار: يشكل السد نقطة جذب للمستثمرين في قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية.
– تعزيز الموقع الجيوسياسي: يدعم المشروع استراتيجية إثيوبيا الرامية إلى قيادة منطقة القرن الأفريقي، ويمنحها أداة دبلوماسية مهمة في علاقاتها مع جيرانها.
التوليد والديناميكية الاقتصادية: رهان الكهرباء والطاقة
تتطلع إثيوبيا إلى سد النهضة كحل لأزمة الطاقة التي تعاني منها، حيث لا يزال أكثر من 60 مليون مواطن بدون كهرباء. من المتوقع أن يغطي السد احتياجات 60% من السكان، ويرفع إنتاج البلاد من الكهرباء من 4478 ميغاواط إلى حوالي 12000 ميغاواط خلال السنوات المقبلة. وتسعى إثيوبيا من خلاله إلى التحول من مستهلك للطاقة إلى أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا، مستهدفة أسواقاً إقليمية مثل السودان وكينيا وجنوب أفريقيا.
لطالما نظرت إثيوبيا إلى السد باعتباره مفتاحًا لمستقبلها الاقتصادي. فهو سيضيء المنازل والمصانع، حيث لا يزال أكثر من نصف السكان يعيشون دون كهرباء. كما يطمح القادة الإثيوبيون لتحويل بلادهم إلى مصدّر رئيسي للطاقة في المنطقة، مما يعزز مكانتها الجيوسياسية ويجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الصناعة والبنية التحتية. ومن منظور الباحث موسى كريسبوس أوكيلو، تجاوز سد النهضة الإثيوبي الكبير كونه مشروعًا للبنية التحتية ليصبح مشروعًا قوميًا موحدًا، تم تمويله بشكل كبير من خلال التبرعات الشعبية. ويُبرز أوكيلو الأهمية الإستراتيجية للسد، الذي يُعد أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا، مشيرًا إلى أن آثاره الاقتصادية المتوقعة تشمل تلبية الطلب المحلي على الطاقة لعدد سكان يبلغ 135 مليون نسمة، وتمكين إثيوبيا من تصدير الطاقة لتحقيق التفوق الإقليمي وزيادة إيراداتها من النقد الأجنبي.
المخاوف المصرية–السودانية: الأمن المائي أمام معضلة فعلية
من جهة أخرى، تُعبر مصر والسودان عن مخاوف عميقة بشأن تأثير السد على حصتهما المائية. فمصر، التي يعتمد أكثر من 100 مليون مواطن على مياه النيل في الشرب والزراعة والصناعة، تخشى انخفاض التدفق المائي. فالقاهرة تخشي من أن يؤدي ملء وتشغيل السد إلى تقليل حصتها من المياه، مما يعرّض الزراعة والصناعة وأمنها المائي للخطر، ويؤثر مباشرة على حياة أكثر من 100 مليون مواطن.
أما السودان، فيتوجس من التغيرات المحتملة في جدولة المياه وما قد ينتج عنها من فيضانات أو جفاف. وهنا تتقاطع المشاعربين القلق والأمل. من ناحية، يخشى من عدم انتظام تدفق المياه والآثار غير المتوقعة على سدوده الخاصة، مما قد يسبب فيضانات مفاجئة أو جفافًا. ومن ناحية أخرى، يرى إمكانية الاستفادة من الكهرباء الرخيصة التي سيولدها السد وتنظيم جريان النهر الذي قد يقلل من آثار الفيضانات المدمرة.
الخلاف يتمحور حول غياب اتفاقية قانونية ملزمة تحدد آلية ملء وتشغيل السد، وتضمن حقوق جميع الأطراف، وتوفر آليات واضحة لحل النزاعات. وتطالب مصر والسودان بضمانات دولية وشفافية كاملة في إدارة السد. لقد فشلت سنوات من المفاوضات، برعاية إقليمية ودولية، في كسر الحلقة المفرغة من الشك وعدم الثقة.
ما هو عمر السدود (الشيخوخة):
عمر السدود يختلف بناءً على نوع البناء والمواد المستخدمة، إلا أن المتوسط المتوقع لعمر السد النموذجي يتراوح بين 50 إلى 100 عام. العديد من السدود التي بنيت في العالم، خاصة خلال فترة 1930 حتى 1970، تدخل الآن مرحلة “الشيخوخة” حيث تبدأ تظهر عليها علامات التآكل والتآكل الهيكلي، مما يجعلها معرضة لمخاطر الانهيار إذا لم تُجرَ صيانة أو تطوير مستمر. بعد انتهاء العمر الافتراضي، قد تواجه السدود مشاكل خطيرة مثل التسربات، ضعف الاستقرار البنيوي، وأحيانًا انهيار كلي، وهو ما يهدد حياة الملايين الذين يعتمدون على هذه المنشآت في ري الأراضي، توفير مياه الشرب، وإنتاج الطاقة الكهرومائية.
هذه التحديات تزداد تعقيدًا مع تغير المناخ، إذ تؤدي الفيضانات الشديدة، هطول الأمطار غير المتوقع، أو الجفاف إلى زيادة الضغط على السدود القديمة، وتفاقم خطر الفشل. لذلك، يصبح من الضروري تحديث أو إزالة بعض السدود أو بناء سدود جديدة بأحدث التقنيات لتأمين استدامة الموارد المائية والطاقة.
بالتالي، سدود اليوم تحتاج إلى مراقبة مستمرة، استثمارات ضخمة في الصيانة والتجديد، ورقابة علمية دقيقة لتقليل الخطر وضمان استمرار الفوائد التي تقدمها للأجيال القادمة. فكارثة الليبية بمثابة جرس إنذار مدوٍّ صدع العالم: سدودنا العجوز تنهار! الانهيار الذي مزق ليبيا وأودى بآلاف الأرواح لم يكن قدراً محتوماً، بل كان إهمالاً يمكن تفاديه. إنها هياكل شائخة، تجاوزت عمرها بعقود، وتحولت إلى قنابل مائية موقوتة تنتظر اللحظة المناسبة للانفجار. وتقف البنية التحتية المائية للعالم على شفا أزمة، وتتصدر الصين والهند قائمة الدول الأكثر تهديداً، حيث توشك 28 ألف سد – هي إرث حقبة منتصف القرن العشرين – على بلوغ نهاية عمرها الافتراضي. خذوا مثالاً صارخاً: سد “مولابيريار” في الهند، الذي تجاوز عمره القرن وهو يعاني تشققات خطرة في منطقة زلزالية، ما يجعله تهديداً مباشراً لحياة 3.5 مليون نسمة. أما في الولايات المتحدة، القوة الثانية عالمياً في هذا المجال، فإن الشيخوخة تمثل تحدياً وجودياً، مع وجود 2200 منشأة مائية على قائمة الخطر المباشر للانهيار.
أخيرا: بين الحلم والسياسة ورسائل سد النهضة
يمثل سد النهضة نقلة نوعية لإثيوبيا، وينقلها من هامش التنمية إلى مركز التأثير في القارة. فهو يجسد حلمًا داخليًا كبيرًا، ويُعد في الوقت نفسه ساحة للصراع الدبلوماسي الإقليمي. وإذا ما أُدير المشروع بشكل متوازن يحترم مصالح جميع الأطراف، فقد يصبح نموذجاً للتعاون والتنمية المستدامة. أما إذا فشلت إدارته، فقد يفتح الباب أمام أزمات غير مسبوقة في المنطقة. افتتاح سد النهضة الجميع أمام مسؤولية تاريخية. إنه اختبار حقيقي لإرادة التعاون الإقليمي. يمكن للمشروع، إذا ما أُدير بحكمة وشفافية، أن يصبح نموذجًا للتنمية المشتركة والتعاون الذي يعود بالنفع على جميع الأطراف ويكون نقطة انطلاق لعهد جديد من التعاون الإقليمي والازدهار المشترك، أو أن يصبح مصدراً للتوتر والصراع. مصير المنطقة رهن بالإرادة السياسية والحكمة، وقدرة النهر على البقاء شريان حياة لا مصدراً للنزاعات. ولكن إذا ساد منطق الأحادية وفرض الأمر الواقع، فقد يشعل شرارة صراع على المياه في منطقة ظلت تعاني من عدم الاستقرار، محولاً نهر النيل، شريان الحياة، إلى مصدر للتوتر والصراع لأجيال قادمة.





